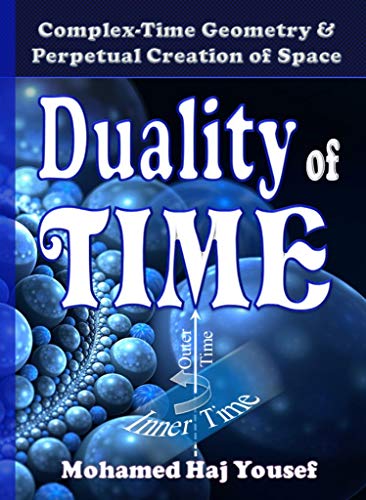و لو لا أن الشرع عرف بانقضاء مدة هذه الدار، و أن"كل نفس ذائقة الموت"، و عرف بالاعادة، و عرف بالدار الآخرة، و عرف بان الإقامة فيها، في النشاة الآخرة، إلى غير نهاية، -ما عرفنا ذلك، و ما خرجنا في كل حال: من موت، و إقامة، و بعث أخراوى، و نشاة أخرى، و جنان، و نعيم، و نار، و عذاب، -بأكل محسوس، و شرب محسوس، و نكاح محسوس و لباس على المجرى الطبيعي. فعلم اللّٰه، أوسع و أتم.
و الجمع بين العقل و الحس، و المعقول و المحسوس، أعظم في القدرة، و أتم في الكمال الإلهي. ليستمر له-سبحانه! -، في كل صنف من الممكنات، حكم"عالم الغيب و الشهادة"، و يثبت حكم"الاسم الظاهر و الباطن" في كل صنف.
(المعاد-أي الحشر-هو جسمانى و روحانى)
فان فهمت فقد وفقت! و تعلم أن العلم الذي اطلع عليه النبيون و المؤمنون، من قبل الحق، أعم تعلقا من علم المنفردين بما تقتضيه العقول، مجردة عن الفيض الإلهي. فالأولى، بكل ناصح نفسه، الرجوع إلى ما قالته الأنبياء و الرسل (بشأن المعاد و الحشر) على الوجهين، المعقول و المحسوس. إذ لا دليل للعقل يحيل ما جاءت به الشرائع، على تأويل مثبتى (المعاد) المحسوس من ذلك، و (المعاد) المعقول (-الروحاني) . فالامكان باق حكمه. و المرجح موجود. فبما ذا يحيل؟ و ما أحسن قول القائل:
زعم المنجم و الطبيب، كلاهما، لا تبعث الأجسام. قلت: إليكم
إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولى، فالخسار عليكما!