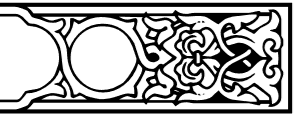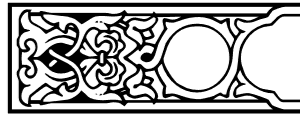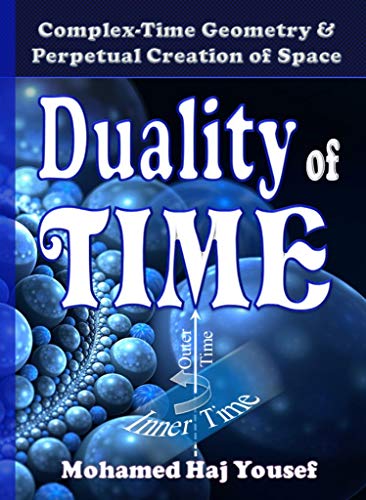«الذين يؤمنون» يصدِّقون «بالغيب» بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار «ويقيمون الصلاة» أي يأتون بها بحقوقها «ومما رزقناهم» أعطيناهم «ينفقون» في طاعة الله.
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)
أصل التكاليف مشتق من الكلف وهي المشقات «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» وهو ما آتاها من التمكن الذي هو وسعها ، فقد خلق سبحانه لنا التمكن من فعل بعض الأعمال ، نجد ذلك من نفوسنا ولا ننكره ، وهي الحركة الاختيارية ، كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا ، ونجد ذلك من نفوسنا ، كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها ، وبذلك القدر من التمكن الذي يجده الإنسان في نفسه صح أن يكون مكلفا ، ولا يحقق الإنسان بعقله لما ذا يرجع ذلك التمكن ، هل لكونه قادرا أو لكونه مختارا ؟ وإن كان مجبورا في اختياره ، ولا يمكن رفع الخلاف في هذه المسألة ، فإنها من المسائل المعقولة ولا يعرف الحق فيها إلا بالكشف ، وإذا بذلت النفس الوسع في طاعة اللّه لم يقم عليها حجة ،
فإن اللّه أجلّ أن يكلف نفسا إلا وسعها ، ولذلك كان الاجتهاد في الفروع والأصول «لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» لما كانت النفوس ولاة الحق على الجوارح ، والجوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيما تصرف فيه ، مطيعة بكل وجه ، والنفوس ليست كذلك ، فإذا عملت لغير عبادة لا يقبل العمل من حيث القاصد لوقوعه الذي هو النفس المكلفة ، لكن من حيث أن العمل صدر من الجوارح أو من جارحة مخصوصة ، فإنها تجزى به تلك الجارحة ، فيقبل العمل لمن ظهر منه ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح شيء إذا كان العمل خيرا بالصورة كصلاة المرائي والمنافق وجميع ما يظهر على جوارحه من أفعال الخير الذي لم تقصد به النفس عبادة ، وأما أعمال الشر المنهي عنها فإن النفس تجزى بها للقصد ، والجوارح لا تجزى بها لأنها ليس في قوتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات ، فإنها مجبورة على السمع والطاعة لها ، فإن جارت النفوس فعليها ، وللجوارح رفع الحرج ، بل لهم الخير الأتم ، وإن عدلت النفوس فلها وللجوارح ، لذلك قال تعالى : «لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» فميز اللّه بين الكسب والاكتساب باللام وعلى ، وهذه الآية بشرى من اللّه حيث جعل المخالفة اكتسابا والطاعة كسبا ، فقال : «لَها ما كَسَبَتْ» فأوجبه لها .
وقال في المعصية والمخالفة : «وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» فما أوجب لها الأخذ بما اكتسبته ، فالاكتساب ما هو حق لها فتستحقه ، فتستحق الكسب ولا تستحق الاكتساب ، والحق لا يعامل إلا بالاستحقاق ، والعفو من اللّه يحكم على الأخذ بالجريمة «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» اعلم أن الرحمة أبطنها اللّه في النسيان الموجود في العالم ، وأنه لو لم يكن لعظم الأمر وشق ، وفيما يقع فيه التذكر كفاية ، وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم وبين اللّه في موطن التكليف ، إذ كانت المعاصي والمخالفات مقدرة في علم اللّه فلا بد من وقوعها من العبد ضرورة ، فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من اللّه حيث يشهده ويراه ، والقدر حاكم بالوقوع فاحتجب رحمة بالخلق لعظيم المصاب ، قال صلّى اللّه عليه وسلم:
إن اللّه إذا أراد نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم ، حتى إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، فلا يؤاخذهم اللّه به في الدنيا ولا في الآخرة ، فأما في الآخرة فمجمع عليه من الكل ، وأما في الدنيا فأجمعوا على رفع الذنب ، واختلفوا في الحكم ، وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في
أشخاص المسائل ، مثل الإفطار ناسيا في رمضان وغير ذلك من المسائل ، فإن اللّه تعالى الذي شرع المعصية والطاعة وبيّن حكمهما ، رفع حكم الأخذ بالمعصية في حق الناسي والمخطئ «رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» وهذا تعليم من الحق لنا أن نسأله في أن لا يقع منه في المستقبل ما لم يقع في الحال ، «وَاعْفُ عَنَّا» أي كثر خيرك لنا وقلل بلاءك عنا ، أي قلل ما ينبغي أن يقلل وكثر ما ينبغي أن يكثر ، فإن العفو من الأضداد يطلق بإزاء الكثرة والقلة ، وليس إلا عفوك عن خطايانا التي طلبنا منك أن تسترنا عنها حتى لا تصيبنا ، وهو قولنا : «وَاغْفِرْ لَنا» أي استرنا من المخالفات حتى لا تعرف مكاننا فتقصدنا «وَارْحَمْنا» برحمة الامتنان ورحمة الوجوب ، أي برحمة الاختصاص.
------------
(286) التنزلات الموصلية - الفتوحات ج 1 /
341 - ج 2 /
381 - ج 3 /
348 ، 123 ، 511 - ج 2 /
535 ، 684 - ج 3 /
381 - ج 1 /
435 ، 434
( الذين يؤمنون بالغيب )
قال أبو جعفر الرازي ، عن العلاء بن المسيب بن رافع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : الإيمان التصديق .
وقال علي بن أبي طلحة وغيره ، عن ابن عباس ، ( يؤمنون ) يصدقون .
وقال معمر عن الزهري : الإيمان العمل .
وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : ( يؤمنون ) يخشون .
قال ابن جرير وغيره : والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان ، الذي هو تصديق القول بالعمل ، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله ، وتصديق الإقرار بالفعل . قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض ، وقد يستعمل في القرآن ، والمراد به ذلك ، كما قال تعالى : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) [ التوبة : 61 ] ، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) [ يوسف : 17 ] ، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال ؛ كقوله : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) [ الانشقاق : 25 ، والتين : 6 ] ، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا .
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة ، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة .
ومنهم من فسره بالخشية ، لقوله تعالى : ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب ) [ الملك : 12 ] ، وقوله : ( من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) [ ق : 33 ] ، والخشية خلاصة الإيمان والعلم ، كما قال تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر : 28 ] .
وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه ، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد .
قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، في قوله : ( يؤمنون بالغيب ) قال : يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وجنته وناره ولقائه ، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث ، فهذا غيب كله .
وكذا قال قتادة بن دعامة .
وقال السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة ، وأمر النار ، وما ذكر في القرآن .
وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( بالغيب ) قال : بما جاء منه ، يعني : من الله تعالى .
وقال سفيان الثوري ، عن عاصم ، عن زر ، قال : الغيب : القرآن .
وقال عطاء بن أبي رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب .
وقال إسماعيل بن أبي خالد : ( يؤمنون بالغيب ) قال : بغيب الإسلام .
وقال زيد بن أسلم : ( الذين يؤمنون بالغيب ) قال : بالقدر . فكل هذه متقاربة في معنى واحد ؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به .
وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا ، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به ، قال : فقال عبد الله : إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه ، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب ، ثم قرأ : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله : ( المفلحون ) [ البقرة : 1 - 5 ] .
وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم في مستدركه ، من طرق ، عن الأعمش ، به .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .
وفي معنى هذا الحديث الذي رواه [ الإمام ] أحمد ، حدثنا أبو المغيرة ، أخبرنا الأوزاعي ، حدثني أسيد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن دريك ، عن ابن محيريز ، قال : قلت لأبي جمعة : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم ، أحدثك حديثا جيدا : تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ، فقال : يا رسول الله ، هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك . قال : نعم ، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني .
طريق أخرى : قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن صالح بن جبير ، قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ، ليصلي فيه ، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة ، فلما انصرف خرجنا نشيعه ، فلما أراد الانصراف قال : إن لكم جائزة وحقا ؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلنا : هات رحمك الله قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة ، فقلنا : يا رسول الله ، هل من قوم أعظم أجرا منا ؟ آمنا بك واتبعناك؟ قال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء ، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين .
ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة ، عن مرزوق بن نافع ، عن صالح بن جبير ، عن أبي جمعة ، بنحوه .
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث ، كما قررته في أول شرح البخاري ؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا .
وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي : حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي ، عن المغيرة بن قيس التميمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الخلق أعجب إليكم إيمانا ؟ . قالوا : الملائكة . قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ . قالوا : فالنبيون . قال : وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ . قالوا : فنحن . قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها .
قال أبو حاتم الرازي : المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث .
قلت : ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده ، وابن مردويه في تفسيره ، والحاكم في مستدركه ، من حديث محمد بن أبي حميد ، وفيه ضعف ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله أو نحوه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا ، والله أعلم .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ، حدثنا إسحاق بن إدريس ، أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري ، أخبرني جعفر بن محمود ، عن جدته تويلة بنت أسلم ، قالت : صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة ، فاستقبلنا مسجد إيلياء ، فصلينا سجدتين ، ثم جاءنا من يخبرنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام ، فتحول النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، فصلينا السجدتين الباقيتين ، ونحن مستقبلون البيت الحرام .
قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال : أولئك قوم آمنوا بالغيب .
هذا حديث غريب من هذا الوجه .
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ابن عباس : ( ويقيمون الصلاة أي : يقيمون الصلاة بفروضها .
وقال الضحاك ، عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها وفيها .
وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها ، ووضوئها ، وركوعها وسجودها .
وقال مقاتل بن حيان : إقامتها : المحافظة على مواقيتها ، وإسباغ الطهور فيها ، وتمام ركوعها وسجودها ، وتلاوة القرآن فيها ، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها .
وقال علي بن أبي طلحة ، وغيره عن ابن عباس : ( ومما رزقناهم ينفقون قال : زكاة أموالهم .
وقال السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومما رزقناهم ينفقون قال : هي نفقة الرجل على أهله ، وهذا قبل أن تنزل الزكاة .
وقال جويبر ، عن الضحاك : كانت النفقات قربات ، يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم ، حتى نزلت فرائض الصدقات : سبع آيات في سورة " براءة " ، مما يذكر فيهن الصدقات ، هن الناسخات المثبتات .
وقال قتادة : ( ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله ؛ هذه الأموال عواري ، وودائع عندك يا ابن آدم ، يوشك أن تفارقها .
واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات ؛ فإنه قال : وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ، زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل ، أو عيال ، وغيرهم ، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك ، وغير ذلك ؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك ، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه .
قلت : كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال ؛ فإن الصلاة حق الله وعبادته ، وهي مشتملة على توحيده ، والثناء عليه ، وتمجيده ، والابتهال إليه ، ودعائه ، والتوكل عليه ، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم ، وأولى الناس بذلك القرابات ، والأهلون ، والمماليك ، ثم الأجانب ، فكل من النفقات الواجبة ، والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . والأحاديث في هذا كثيرة .
وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء ، قال الأعشى :
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما
وقال أيضا :
وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم
أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . وقال الآخر :
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
يقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي . وهذا ظاهر ، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة ، بشروطها المعروفة ، وصفاتها ، وأنواعها [ المشروعة ] المشهورة .
وقال ابن جرير : وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة ؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله ، مع ما يسأل ربه من حاجته .
[ وقيل : هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع ، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب ، ومنه سمي المصلي ؛ وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل ، وفيه نظر ، وقيل : هي مشتقة من الصلى ، وهو الملازمة للشيء من قوله : ( لا يصلاها ) أي : يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى ) [ الليل : 15 ] وقيل : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم ، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) [ العنكبوت : 45 ] واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر ، والله أعلم ] .
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه ، إن شاء الله .
الأولى:قوله تعالى{الذين} في موضع خفض نعت {للمتقين}، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح. {يؤمنون} يصدقون. والإيمان في اللغة : التصديق، وفي التنزيل{وما أنت بمؤمن لنا} [
يوسف: 17 ]. أي بمصدق، ويتعدى بالباء واللام، كما قال{ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم}[
آل عمران :73 ] { فما آمن لموسى} [
يونس: 83 ]. و روى حجاج بن حجاج الأحول - ويلقب بزقّ العسل - قال سمعت قتادة يقول : يا ابن آدم، إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط فإن نفسك مائلة إلى السأمة والفترة والملة، ولكن المؤمن هو المتحامل، والمؤمن هو المتقوي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله الليل والنهار، والله ما يزال المؤمن يقول : ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم في السر والعلانية. الثانية: قوله تعالى {بالغيب} الغيب في كلام العرب : كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء يقال منه : غابت الشمس تغيب، والغيبة معروفة. وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة من الأرض، والغيابة : الأجمة، وهي جماع الشجر يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض : الغيب، لأنه غاب عن البصر. الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة : الغيب في هذه الآية : الله سبحانه. وضعفه ابن العربي. وقال آخرون : القضاء والقدر. وقال آخرون : القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون : الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية : وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها. قلت : وهذا الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : فأخبرني عن الإيمان. قال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال : صدقت. وذكر الحديث. وقال عبدالله بن مسعود : ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ{الذين يؤمنون بالغيب} [
البقرة: 3 ]. قلت : وفي التنزيل{وما كنا غائبين} [
الأعراف:7 ]. وقال{الذين يخشون ربهم بالغيب} [
الأنبياء: 49 ]. فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئي في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس، لعلمهم بإطلاعه عليهم، وعلى هذا تتفق الآي ولا تتعارض، والحمد لله. وقيل{بالغيب} أي بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين، وهذا قول حسن. وقال الشاعر : وبالغيب أمنا وقد كان قومنا ** يصلّون للأوثان قبل محمد الرابعة: قوله تعالى{ويقيمون الصلاة} معطوف جملة على جملة. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، على ما يأتي بيانه. يقال : قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك : قام الحق أي ظهر وثبت، قال الشاعر : وقامت الحرب بنا على ساق وقال آخر : وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا ** حتى تقيم الخيل سوق طعان وقيل{يقيمون} يديمون، وأقامه أي أدامه، وإلى هذا المعنى أشار عمر بقوله : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الخامسة: إقامة الصلاة معروفة، وهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي واجبة وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر، وروي عن مالك، واختاره ابن العربي قال : لأن في حديث الأعرابي (وأقم) فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. قال : فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث وهي أن الإقامة فرض. قال ابن عبدالبر قوله : (وتحريمها التكبير) دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض علمائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن، والله أعلم. السادسة: واختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام : (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك). وهذا نص. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقال إسحاق : يسرع إذا خاف فوات الركعة، وروي عن مالك نحوه، وقال : لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس، وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب، لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي. قلت : واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار، لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر، فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي، حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة، وما خرجه الدارمي في مسنده قال : حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عُجْرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة). فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلي، وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى{فاسعوا إلى ذكر الله} [
الجمعة:9 ]. وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام، وإنما عنى العمل والفعل، هكذا فسره مالك. وهو الصواب في ذلك والله أعلم. السابعة: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام : (وما فاتكم فأتموا) وقوله : (واقض ما سبقك) هل هما بمعنى واحد أو لا؟ فقيل : هما بمعنى واحد وأن القضاء قد يطلق ويراد به التمام، قال الله تعالى{فإذا قضيت الصلاة} [
الجمعة: 10 ]. وقال{فإذا قضيتم مناسككم} [
البقرة: 200 ]. وقيل : معناهما مختلف وهو الصحيح، ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل هل هو أول صلاته أو أخرها؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك - منهم ابن القاسم - ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة، فيكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال. قال ابن عبدالبر : وهو المشهور من المذهب. وقال ابن خويز منداد : وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن علي. و روى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبدالحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك، أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقوال، وهو قول الكوفيين. قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب : وهو مشهور مذهب مالك. قال ابن عبدالبر : من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام، لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في أخرها، فمن ههنا قالوا : إن ما أدرك فهو أول صلاته، مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله : (فأتموا) والتمام هو الآخر. واحتج الآخرون بقوله : (فاقضوا) والذي يقضيه هو الفائت، إلا أن رواية من روى {فأتموا} أكثر، وليس يستقيم على قول من قال : إن ما أدرك أول صلاته ويطرد، إلا ما قاله عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجِشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها، فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم، رضي الله عنهم. الثامنة: الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) خّرجه مسلم وغيره، فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها، لقوله تعالى{ولا تبطلوا أعمالكم}[
محمد: 33 ]. وخاصة إذا صلى ركعة منها. وقيل : يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. التاسعة: واختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة، فقال مالك : يدخل مع الإمام ولا يركعهما، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد - التي تصلى فيها الجمعة - اللاصقة بالمسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه، ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد، ثم يدخل مع الإمام وكذلك قال الأوزاعي، إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة. وقال الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال الحسن بن حي ويقال ابن حيان : إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. وقال الشافعي : من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن مالك، وهو الصحيح في ذلك، لقوله عليه السلام. (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). وركعتا الفجر إما سنة، وإما فضيلة، وإما َرغِيبة، والحجة عند التنازع حجة السنة. ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة، ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة الثوري والأوزاعي ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه دخل المسجد. وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر، ثم دخل الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما. قالوا : (وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد)، روى مسلم عن عبدالله بن مالك ابن بُحَينة قال : أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال : (أتصلي الصبح أربعا) وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على الرجل لصلاته ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي، ويمكن أن يستدل به أيضا على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت، لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك، والله أعلم. العاشرة: الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، ومنه قوله عليه السلام : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل) أي فليدع. وقال بعض العلماء : إن المراد الصلاة المعروفة، فيصلي ركعتين وينصرف، والأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر. ولما ولدت أسماء عبدالله بن الزبير أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء : ثم مسحه وصلى عليه، أي دعا له. وقال تعالى{وصل عليهم} [
التوبة: 103 ]. أي ادع لهم. وقال الأعشى : تقول بِنتي وقد قرُبتُ مرتحلا ** يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليكِ مثلَ الذي صليتِ فاغتمضي ** نوما فإن لجنب المرء مضطجعا وقال الأعشى أيضا : وقابلها الريح في دِنِّها ** وصلّى على دنها وارتسم ارتسم الرجل : كبر ودعا، قال في الصحاح، وقال قوم : هي مأخوذة من الصلا وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه، ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل، لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صَلْوَي السابق، فاشتقت الصلاة منه، إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل، وإما لأن الراكع تثنى صلَواه. والصلاة : مغرز الذنب من الفرس، والاثنان صلوان. والمصلي : تالي السابق، لأن رأسه عند صلاه. وقال علي رضي الله عنه : سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلّث عمر. وقيل : هي مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه {تصلى نارا حامية} [
الغاشية: 4] . وقال الحارث بن عُباد : لم أكن من جُناتها علم اللـ ** ـه وإني بحرها اليوم صال أي ملازم لحرها، وكأن المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به. وقيل : هي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاء. والصلاء : صلاء النار بكسر الصاد ممدود، فإن فتحت الصاد قصرت، فقلت صلا النار، فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع، قال الخارزنجي : فلا تعجل بأمرك واستدمه ** فما صلى عصاك كمستديم والصلاة : الدعاء والصلاة : الرحمة، ومنه : (اللهم صل على محمد) الحديث. والصلاة : العبادة، ومنه قوله تعالى{وما كان صلاتهم عند البيت} [
الأنفال:35 ]. أي عبادتهم. والصلاة : النافلة، ومنه قوله تعالى{وأمر أهلك بالصلاة}[
طه: 132 ]. والصلاة التسبيح، ومنه قوله تعالى{فلولا أنه كان من المسبحين} [
الصافات: 143 ]. أي من المصلين. ومنه سبحة الضحى. وقد قيل في تأويل {نسبح بحمدك} [
البقرة: 30 ]. نصلي. والصلاة : القراءة، ومنه قوله تعالى{ولا تجهر بصلاتك} [
الإسراء: 110 ]. فهي لفظ مشترك. والصلاة : بيت يصلّى فيه، قاله ابن فارس. وقد قيل : إن الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة، فإن الله تعالى لم يخل زمانا من شرع، ولم يخل شرع من صلاة، حكاه أبو نصر القشيري. قلت : فعلى هذا القول لا اشتقاق لها، وعلى قول الجمهور وهي : - الحادية عشرة: اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا اختلافهم والأول أصح، لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، ولكن للعرب تحكم في الأسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدب، ثم خصصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء، والله أعلم. الثانيةعشرة: واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل : الفرائض. وقيل : الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام والمتقي يأتي بهما. الثالثةعشرة : الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى{وأمر أهلك بالصلاة} [مريم 132 ]. الآية، على ما يأتي بيانه في {طه} إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره، روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال : هجّر النبي صلى الله عليه وسلم فهجّرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (أشكمت درده) قلت : نعم يا رسول الله، قال : (قم فصل فإن في الصلاة شفاء). في رواية : (أشكمت درد) يعني تشتكي بطنك بالفارسية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الرابعة عشرة: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها : الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة. وستر العورة، يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما فروضها : فاستقبال القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخلّ بها، فقال له : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) خّرجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع، أخرجه الدارقطني وغيره. قال علماؤنا : فبين قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات، وعن التسبيح في الركوع والسجود، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما. وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء، لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام. وقال بعض أصحابه : الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة، وهو قول الحميدي، ورواية عن الأوزاعي. واحتجوا بقوله عليه السلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي) أخرجه البخاري. قالوا : فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل، لأنه المبلغ عن الله مراده. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور. وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول : من أسقط من التكبيرة في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد قبل السلام، وإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضا للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها فيها. وهذا يدل على أن عُظْم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصْبَغ بن الفرج وعبدالله بن عبدالحكم : ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن تركه ساهيا سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه، ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا، لأنه سنة من سنن الصلاة، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية. قلت : هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم البخاري رحمه الله (باب إتمام التكبير في الركوع والسجود) وساق حديث مُطرّف بن عبدالله قال : صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال : لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال : لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث عكرمة قال : رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال : أو ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أُمّ لك فدلّك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم. روى أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال : صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بهذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، قال أبو موسى : فإما نسيناها وإما تركناها عمدا. قلت : أتراهم أعادوا الصلاة فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه، وبالله التوفيق. الخامسة عشرة: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور، وأوجبه إسحاق بن راهويه، وأن من تركه أعاد الصلاة، لقوله عليه السلام : (أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم ). السادسةعشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه : الجلوس الأول والتشهد له سنتان. وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول وقالوا : هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا من المزابنة، والقراض من الإجارات، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا. واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. احتج من لم يوجبه بأن قال : لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به، كما لو ترك سجدة أو ركعة، ويراعى فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة، ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبدالله بن بُحينة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائما فقاموا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم، فلو كان الجلوس فرضا لم يسقطه النسيان والسهو، لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المؤتم. واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك .وهي : السابعة عشرة: على خمسة أقوال : أحدها : أن الجلوس فرض والتشهيد فرض والسلام فرض. وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود. قال الشافعي : من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض، لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل وقد قال صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) القول الثاني : أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية، وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (وفي النسخة : العاصي) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته) وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب المقتبس. وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس. القول الثالث : إن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي عبدالرحمن بن زياد وهو ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته). قال ابن العربي : وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس : ويرى الخروج من الصلاة بضرطة ** أين الضراط من السلام عليكم قال ابن العربي : وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين، أما أحدهما : فروى عبدالملك عن عبدالملك أن من سلم من ركعتين متلاعبا، فخرج البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئه، وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يجزئ من خلفه، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى، وإن عمرت به المجالس للذكرى. القول الرابع : إن الجلوس فرض والسلام فرض، وليس التشهد بواجب. وممن قال هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية. واحتجوا بأن قالوا : ليس شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن. القول الخامس : أن التشهد والجلوس واجبان، وليس السلام بواجب، قاله جماعة منهم إسحاق بن راهويه، واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال له : (إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك). قال الدارقطني : قوله (إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك) أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشبابة ثقة. وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك، جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة: واختلف العلماء في السلام، فقيل : واجب، وقيل : ليس بواجب. والصحيح وجوبه لحديث عائشة وحديث علي الصحيح خرجه أبو داود والترمذي ورواه سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ عنهما غيرهما كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق. قال عبدالرحمن بن مهدي : لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه، وهذا تصحيح من عبدالرحمن بن مهدي لحديث علي، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحسبك به! وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي: التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبدالرحمن وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة، وهو الصواب وعليه الجمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة. الموفية عشرين: واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة، فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء : لا يجزئ إلا التكبير، لا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين، ولا يجزئ عند مالك إلا الله أكبر لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد : ويجزئ الله الأكبر و الله الكبير والحجة لمالك حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين}. وحديث علي : وتحريمها التكبير. وحديث الأعرابي : فكبر. وفي سنن ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قالا : حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبدالحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير، قال الشاعر : رأيت الله أكبر كل شيء ** محاولة وأعظمه جنودا ثم إنه يتضمن القدم، وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى، والله أعلم. وقال أبو حنيفة : إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه، وإن قال : اللهم اغفر لي لم يجزه، وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف : لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وكان الحكم بن عتيبة يقول : إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال ابن المنذر : ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة، فمن كان هذا مذهبه فاللازم له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة : يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنذر : لا يجزيه لأنه خلاف ما عليه جماعات المسلمين، وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال. والله أعلم. الحادية والعشرون : واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة، وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربي : والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها، أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها، كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل، وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله. قال ابن العربي : وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان : سمعت إمام الحرمين يقول : يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال : ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل، وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة، ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر عليه سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول قال محمد بن سحنون : رأيت أبي سحنونا ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت له ما هذا؟ فقال : عزبت نيتي في أثنائها فلأجل ذلك أعدتها. قلت : فهذه جملة من أحكام الصلاة، وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى، فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات، وبعض صلاة الخوف في هذه السورة، ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف، في النساء والأوقات في هود وسبحان والروم وصلاة الليل في المزمل وسجود التلاوة في الأعراف وسجود الشكر في ص كل في موضعه إن شاء الله تعالى. الثانية والعشرون : قوله تعالى{ومما رزقناهم ينفقون} رزقناهم : أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم : إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. قالوا : فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصا، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. وهذا فاسد، والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه. والذي يدل على أنه لا رازق سواه قول الحق{هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض} [
فاطر: 3 ]. وقال{إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [
الذاريات:51 ] . وقال{وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [
هود: 6 ]. وهذا قاطع، فالله تعالى رازق حقيقة وابن آدم تجوّزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق. وقد خرّج بعض النبلاء من قوله تعالى{كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور} [سبأ: 15 ]. فقال : ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. الثالثة والعشرون: قوله تعالى{ومما رزقناهم} الرزق مصدر رزق يرزق رَزقا ورِزقا، فالرزق بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم، وجمعه أرزاق، والرزق : العطاء. والرازقية : ثياب كتان بيض. وارتزق الجند : أخذوا أرزاقهم. والرزقة : المرة الواحدة، هكذا قال أهل اللغة. وقال ابن السكيت : الرزق بلغة أزْدِشَنوءة : الشكر، وهو قوله عز وجل{وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} [
الواقعة: 82 ]. أي شكركم التكذيب. ويقول : رزقني أي شكرني. الرابعة والعشرون: قوله تعالى{ينفقون} ينفقون : يخرجون. والإنفاق : إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع : أي خرج من يد البائع إلى المشتري. ونفقت الدابة : خرجت روحها، ومنه النافقاء لجُحْر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى. ومنه المنافق، لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونَيفق السراويل معروفة وهو مخرج الرجل منها. ونفِق الزاد : فنى وأنفقه صاحبه. وأنفق القوم : فني زادهم، ومنه قوله تعالى{إذا لأمسكتم خشية الإنفاق} [
الإسراء: 100 ]. الخامسة والعشرون: واختلف العلماء في المراد بالنفقة ههنا، فقيل : الزكاة المفروضة - روي عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاة. وقيل : نفقة الرجل على أهله - روي عن ابن مسعود - لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك). وروي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله) قال أبو قِلابة : وبدأ بالعيال [ثم] قال أبو قلابة : وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل : المراد صدقة التطوع - روي عن الضحاك نظرا إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع، فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع. قال الضحاك : كانت النفقة قربانا يتقربون بها إلى الله جل وعز على قدر جِدَتهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة . وقيل : إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها. وقيل : هو عام وهو الصحيح، لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أي يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يعنّ في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. وقيل : الإيمان بالغيب حظ القلب. وإقام الصلاة حظ البدن. ومما رزقناهم ينفقون حظ المال، وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى{ومما رزقناهم ينفقون} أي مما علّمناهم يعلّمون، حكاه أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم القُشيري.
وهم الذين يُصَدِّقون بالغيب الذي لا تدركه حواسُّهم ولا عقولهم وحدها؛ لأنه لا يُعْرف إلا بوحي الله إلى رسله، مثل الإيمان بالملائكة، والجنة، والنار، وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، (والإيمان: كلمة جامعة للإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصديق الإقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان والجوارح) وهم مع تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداءً صحيحًا وَفْق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة.
ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة, والأعمال الظاهرة, لتضمن التقوى لذلك فقال: { الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ } حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل, المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس, فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. إنما الشأن في الإيمان بالغيب, الذي لم نره ولم نشاهده, وإنما نؤمن به, لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر, لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به, أو أخبر به رسوله, سواء شاهده, أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله, أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية, لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم, ومرجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب, [الإيمان بـ] بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة, وأحوال الآخرة, وحقائق أوصاف الله وكيفيتها, [وما أخبرت به الرسل من ذلك] فيؤمنون بصفات الله ووجودها, ويتيقنونها, وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال: { وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ } لم يقل: يفعلون الصلاة, أو يأتون بالصلاة, لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة, إقامتها ظاهرا, بإتمام أركانها, وواجباتها, وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحها, وهو حضور القلب فيها, وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: { إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته, إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة, والنفقة على الزوجات والأقارب, والمماليك ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليهم, لكثرة أسبابه وتنوع أهله, ولأن النفقة من حيث هي, قربة إلى الله، وأتى بـ " من " الدالة على التبعيض, لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم, غير ضار لهم ولا مثقل, بل ينتفعون هم بإنفاقه, وينتفع به إخوانهم. وفي قوله: { رَزَقْنَاهُمْ } إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم, ليست حاصلة بقوتكم وملككم, وإنما هي رزق الله الذي خولكم, وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده, فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم, وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن, لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود, وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه, فلا إخلاص ولا إحسان.
قوله تعالى: {الذين يؤمنون}: موضع الذين خفض نعتاً للمتقين. يؤمنون: يصدقون (ويترك الهمزة أبو عمرو وورش، والآخرون يهمزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل نحو يؤمن ومؤمن إلا أحرفاً معدودة).
وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، قال الله تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا} [17-يوسف] [ أي بمصدق لنا ] وهو في الشريعة: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيماناً، لوجه من المناسبة، لأنه من شرائعه.
والإسلام: هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيماناً، إذا لم يكن معه تصديق، قال الله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [14- الحجرات] وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلماً في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقاً في الباطن غيرمنقاد في الظاهر.
وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حين سأله جبريل عليه السلام؛ وهو ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد البخاري: أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ثنا أبو أحمد عيسى بن أحمد العسقلاني أنا يزيد بن هارون أنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: "كان أول من تكلم في القدر، يعني بالبصرة، معبداً الجهني فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقوله هؤلاء فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل الكلام إلي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إنما الأمر أنف قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء شيئاً حتى يؤمن بالقدر خيره وشره؛ ثم قال: (حدثنا عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم [وركبته تمس ركبته] فقال: يامحمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال: صدقت فتعجبنا من سؤاله وتصديقه، ثم قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسوله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، فقال: صدقت، ثم قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت، ثم قال: فأخبرني عن الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر، قال: صدقت، ثم انطلق فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه)".
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسماً لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه ثنا أبو أحمد بن محمد بن قريش بن سليمان ثنا بشر بن موسى ثنا خلف بن الوليد عن جرير الرازي عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ّ(الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان).
وقيل: الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمناً لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العباد من عذابه.
قوله تعالى: {بالغيب}: والغيب مصدر وضع موضع الاسم فقيل للغائب غيب [كما قيل للعادل عدل وللزائر زور].
والغيب ما كان مغيباً عن العيون؛ قال ابن عباس: "الغيب هاهنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان".
وقيل الغيب هاهنا: هو الله تعالى، وقيل: القرآن.
وقال الحسن: "بالآخرة" وقال زر بن حبيش وابن جريح: "بالوحي". نظيره {أعنده علم الغيب} [35-النجم]
وقال ابن كيسان: "بالقدر"، وقال عبد الرحمن بن يزيد: "كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم [وما سبقونا به] فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بيناً لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ {الم * ذلك الكتاب} إلى قوله {المفلحون}".
قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وورش (يومنون) بترك الهمزة وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في (أنبئهم) و(نبئهم) و(نبئنا) ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو (نبئهم) و(أنبئهم) و(تسؤهم) و(إن نشأ) و(ننسأها) و(نحوها) أو يكون خروجاً من لغة إلى أخرى نحو: (مؤصدة) و(رئياً). ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل إلا (تؤوي) و(تؤويه) ولا يترك من عين الفعل: إلا (الرؤيا) و(بابه)، إلا ما كان على وزن فعل، مثل: (ذئب).
قوله تعالى: {ويقيمون الصلاة}: أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها.
يقال: قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطىً حقوقه.
والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ (الواحد) كقوله تعالى: {فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق} [213-البقرة] يعني الكتب.
والصلاة في اللغة: الدعاء، قال الله تعالى: {وصَلِّ عليهم} [103-التوبة] أي ادع لهم.
وفي الشريعة: اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء.
وقيل في قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [56-الأحزاب] الآية. إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين: الدعاء.
قوله تعالى: {ومما رزقناهم}: (أي) أعطيناهم والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد.
وأصله في اللغة الحظ والنصيب.
{ينفقون}: يتصدقون.
قال قتادة: "ينفقون في سبيل الله وطاعته.
وأصل الإنفاق: الإخراج عن اليد والملك، ومنه نفاق السوق، لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد، ومنه: نفقت الدابة إذا أخرجت روحها.
فهذه الآية في المؤمنين من مشركي العرب.
(الَّذِينَ) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة للمتقين.
(يُؤْمِنُونَ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.
(بِالْغَيْبِ) جار ومجرور متعلقان بالفعل يؤمنون.
وجملة (يُؤْمِنُونَ) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
(وَيُقِيمُونَ) إعرابها مثل يؤمنون. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.
(الصَّلاةَ) مفعول به.
(وَمِمَّا) الواو عاطفة ومن حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر.
(رَزَقْناهُمْ) فعل ماض مبني على السكون، نا فاعل والهاء مفعول به والميم علامة جمع الذكور. والعائد محذوف وهو المفعول الثاني، التقدير مما رزقناهم إياه والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
(يُنْفِقُونَ) فعل مضارع والواو فاعله.