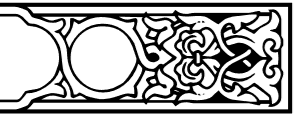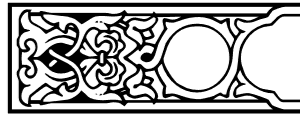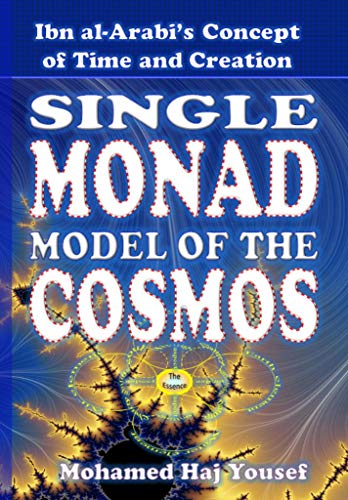«كلا» حقا «لمَّا يقض» لم يفعل «ما أمره» به ربه.
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22)
- الوجه الأول - يعني المزاج الذي كان عليه في الدنيا ، أي هو قادر على إعادة ذلك المزاج ، لكن ما شاء ، ولهذا علق المشيئة به فقال «ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ» فلو كان هو بعينه لقال : ثم ينشره ؛ ولا يعلم أحد ما في مشيئة الحق إلا أن يعلمه الحق بذلك - الوجه الثاني - لما كانت النشأة الآخرة على غير مثال من النشأة الدنيا ، فهو تعالى يخرجنا إخراجا لا نباتا ، فهو يخرجنا من الأرض على الصورة التي يشاء الحق أن يخرجنا عليها ، لذلك علّق المشيئة بنشر الصورة التي أعادها في الأرض الموصوفة بأنها تنبت ، فتنبت على غير مثال لأنه ليس في الصور صورة تشبهها .
------------
(22) الفتوحات ج 3 /
42 - ج 4 /
289 - ج 2 /
472 - ج 3 /
346 ، 438
وقوله ( كلا لما يقض ما أمره ) قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله ( لما يقض ما أمره ) يقول لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل
ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ( كلا لما يقض ما أمره ) قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا والذي يقع لي في معنى ذلك - والله أعلم أن المعنى ( ثم إذا شاء أنشره ) أي بعثه ( كلا لما يقض ما أمره ) [ أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم
وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال : قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق ، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
قوله تعالى {قتل الإنسان ما أكفره}؟ {قتل} أي لعن. وقيل : عذب. والإنسان الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال : ما كان في القرآن {قتل الإنسان} فإنما عني به الكافر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال : نزلت في عتبة بن أبي لهب، وكان قد أمن، فلما نزلت {والنجم} آرتد، وقال : أمنت بالقرآن كله إلا النجم، فأنزل الله جل ثناؤه فيه {قتل الإنسان} أي لعن عتبة حيث كفر بالقرآن، ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : [اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة] فخرج من فوره بتجارة إلى الشام، فلما انتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لمن معه ألف دينار إن هو أصبح حيا، فجعلوه في وسط الرفقة، وجعلوا المتاع حول، فبينما هم على ذلك أقبل الأسد، فلما دنا من الرحال وثب، فإذا هو فوقه فمزقه، وقد كان أبوه ندبه وبكى وقال : ما قال محمد شيئا قط إلا كان. وروى أبو صالح عن ابن عباس {ما أكفره} : أي شيء أكفره؟ وقيل {ما} تعجب؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا : قاتله الله ما أحسنه! وأخزاه الله ما أظلمه؛ والمعنى : اعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل : ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعجب أيضا؛ قال ابن جريج : أي ما أشد كفره! وقيل {ما} استفهام أي أي شيء دعاه إلى الكفر؛ فهو استفهام توبيخ. و{ما} تحتمل التعجب، وتحتمل معنى أي، فتكون استفهاما. قوله تعالى {من أي شيء خلقه} أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ أي اعجبوا لخلقه. {من نطفة} أي من ماء يسير مهين جماد {خلقه} فلم يغلط في نفسه؟! قال الحسن : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين. {فقدره} في بطن أمه. كذا روى الضحاك عن ابن عباس : أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه، وحسنا ودميما، وقصيرا وطويلا، وشقيا وسعيدا. وقيل {فقدره} أي فسواه كما قال {أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا}. وقال {الذي خلقك فسواك}. وقيل {فقدره} أطوارا أي من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة، إلى أن تم خلقه. {ثم السبيل يسره} قال ابن عباس في رواية عطاء وقتادة والسدي ومقاتل : يسره للخروج من بطن أمه. مجاهد : يسره لطريق الخير والشر؛ أي بين له ذلك. دليله {إنا هديناه السبيل} و{هديناه النجدين}. وقاله الحسن وعطاء وابن عباس أيضا في رواية أبي صالح عنه. وعن مجاهد أيضا قال : سبيل الشقاء والسعادة. ابن زيد : سبيل الإسلام. وقال أبو بكر بن طاهر يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه؛ دليله قوله عليه السلام : [اعملوا فكل ميسر لما خلق له]. قوله تعالى {ثم أماته فأقبره} أي جعل له قبرا يواري فيه إكراما، ولم يجعله مما يلقي على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي؛ قاله. الفراء. وقال أبو عبيدة {أقبره} : جعل له قبرا، وأمر أن يقبر. قال أبو عبيدة : ولما قتل عمر بن هبيرة صالح بن عبدالرحمن، قالت بنو تميم ودخلوا عليه : أقبرنا صالحا؛ فقال : دونكموه. وقال {أقبره} ولم يقل قبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده، قال الأعشى : لو أسندت ميتا إلى نحرها ** عاش ولم ينقل إلى قابر يقال : قبرت الميت : إذا دفنته، وأقبره الله : أي صيره بحيث يقبر، وجعل له قبرا؛ تقول العرب : بترت ذنب البعير، وأبتره الله، وعضبت قرن الثور، وأعضبه الله، وطردت فلانا، والله أطرده، أي صيره طريدا. {ثم إذا شاء أنشره} أي أحياه بعد موته. وقراءة العامة {أنشره} بالألف. وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة {شاء نشره} بغير ألف، لغتان فصيحتان بمعنى؛ يقال : أنشر الله الميت ونشره؛ قال الأعشى : حتى يقول الناس مما رأوا ** يا عجبا للميت الناشر قوله تعالى {كلا لما يقض ما أمره} قال مجاهد وقتادة {لما يقض} : لا يقضي أحد ما أمر به. وكان ابن عباس يقول {لما يقض ما أمره} لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. ثم قيل {كلا} ردع وزجر، أي ليس الأمر : كما يقول الكافر؛ فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال {ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى}[
فصلت : 50] ربما يقول قد قضيت ما أمرت به. فقال : كلا لم يقض شيئا بل هو كافر بي وبرسولي. وقال الحسن : أي حقا لم يقض : أي لم يعمل بما أمر به. و{ما} في قوله {لما} عماد للكلام؛ كقوله تعالى {فبما رحمة من الله}[
آل عمران : 159] وقول {عما قليل ليصبحن نادمين}[
المؤمنون : 40]. وقال الإمام ابن فورَك : أي : كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان، بل أمره بما لم يقض له. ابن الأنباري : الوقف على {كلا} قبيح، والوقف على {أمره} و{نشره} جيد؛ فـ {كلا} على هذا بمعنى حقا.
لُعِنَ الإنسان الكافر وعُذِّب، ما أشدَّ كفره بربه!! ألم ير مِن أيِّ شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل- وهو المَنِيُّ- فقدَّره أطوارا، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماته فجعل له مكانًا يُقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه، وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يُؤَدِّ ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته.
وهو -مع هذا- لا يقوم بما أمره الله، ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب.
"كلا"، رداً عليه، أي: ليس كما يقول ويظن هذا الكافر، وقال الحسن: حقاً. "لما يقض ما أمره"، أي لم يفعل ما أمره الله به ولم يؤد ما فرض عليه.
و(كَلَّا) حرف ردع وزجر (لَمَّا يَقْضِ) مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره والفاعل مستتر و(ما) مفعول به و(أَمَرَهُ) ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة ما وجملة كلا.. مستأنفة لا محل لها.
Traslation and Transliteration:
Kalla lamma yaqdi ma amarahu
Nay, but (man) hath not done what He commanded him.
Gerçekten de insan, onun emrini tam yerine getirmedi gitti.
Eh bien non! [L'homme] n'accomplit pas ce qu'Il lui commande.
Gewiß, nein! Er erledigte nicht, was ER ihm gebot.
 |
بيانات السورة |
| اسم السورة |
سورة عبس (Abasa - He Frowned) |
| ترتيبها |
80 |
| عدد آياتها |
42 |
| عدد كلماتها |
133 |
| عدد حروفها |
538 |
| معنى اسمها |
عَبَسَ: قَطَّبَ مَا بَينَ عَيْنَيهِ لِإِبْدَاءِ الاسْتِيَاءِ وَعَدَمِ الرِّضَا. وَالمُرَادُ (بِعَبَسَ): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَبَسَ فِي وَجْهِ الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رضي الله عنه، فَعَاتَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِيُزَكِّي خُلُقَهُ الْعَظِيمَ ﷺ ويُكَمِّلَهُ |
| سبب تسميتها |
انْفِرَادُ السُّورَةِ بِذِكْرِ حَادِثَةِ (عَبَسَ)، وَدِلَالَةُ هَذَا الاسْمِ عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا |
| أسماؤها الأخرى |
اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (عَبَسَ)، وتُسَمَّى سُورَةَ (الْأَعْمَى)، وَسُورَةَ (الْغُرَّةِ)، وَسُورَةَ (الْصَّاخَّةِ) |
| مقاصدها |
دَعْوَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَذْكِيرُهُ بِالنِّعَمِ وَمَصِيرِ مَنْ آمَنَ أَوْ كَذَّبَ بِاللهِ تَعَالَى |
| أسباب نزولها |
سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: «أُنْزِلَتْ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ فِي ابنِ أمِّ مَكْتومٍ الْأَعْمَى، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، وَيَقُولُ: «أَتَرَى فِيمَا أَقُولُ بَأْسًا؟ فَيَقُولُ: لَا، فَفِي هَذَا نَزَلَ». (حَدِيثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ التِّرمِذيُّ) |
| فضلها |
مِنَ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ يَقرَأُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَوَاتِ، فَفِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه الطَّويْلِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ، السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، .... (وَوَيْلٌ لِلْمَطَفِّفِينَ وَعَبَسَ) فِي رَكْعَةٍ». (حَدِيثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) |
| مناسبتها |
مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (عَبَسَ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَعَاقِبَتِهِمَا، فَافْتُتِحَتْ بِصِنْفَيِنِ: الْمُؤْمِنِ الصَّادِقِ وَالْمُسْتَغْنِي الْكَافِرِ، فَقَالَ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ١﴾... الآيَاتِ، وَخُتِمَتْ بِذِكْرِ عَاقِبَتَهُمَا، فقال: ﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ ٣٨ ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ ٣٩﴾... الآيَاتِ.
مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (عَبَسَ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (النَّازِعَاتِ): لَمَّا ذُكِرَ الْإِنْذَارُ فِي آخِرِ (النَّازِعَاتِ) بِقَولِهِ: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىٰهَا ٤٥﴾ بَيَّنَ فِي أَوَّلِ (عَبَسَ) مَنْ يَنْفَعُهُ الْإِنْذَارُ وَمَنْ لَا يَنْفَعُهُ، فَقَالَ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ١ ﴾... الآيَاتِ |