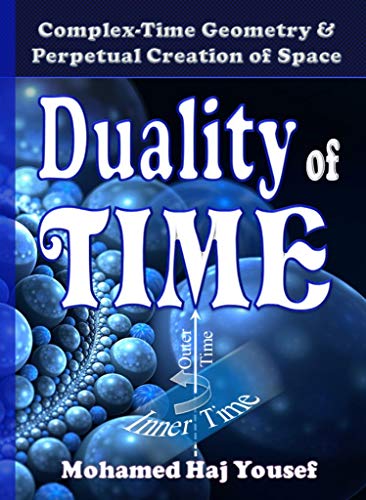المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف
للأمير عبد القادر الحسني الجزائري
 |
 |
226. الموقف السادس والعشرون بعد المائتين
قال تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾[طه: 20/ 50].
المطلوب من الواقف على هذا الموقف أن يعطيه ما يستحقه من التأمل والإنصاف. فإنها مسألة تكسرت في البحث عنها أظافير كثيرين. ليعلم أنَّ الأشياء الممكنة معلومة للحق تعالى ، حالة عدمها بعلم محيط إجمالي، في تفصيل ل يتناهى، والشيئيّة المذكورة في هذه الآية هي الشيئيّة الوجودية:﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ﴾.
أي موجود: (خلقه) طبيعته واستعداده كما هي في قوله: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾[مريم: 19/ 9 ].
أي موجوداً، لا الشيئيّة الثبوتيّة، كما هي في قوله: ﴿إِنَّمَ قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾[النحل: 16/ 40].
وهي الشيئية المعلومة المجردة عن الوجود العيني. ولحقائق الممكنات استعدادات، معلومة له تعالى ثابتة معدومة، وكما أن عدم الممكنات، السابق على وجودها غير مراد ولا مجعول؛ كذلك استعداداتها وطبائعها الكلية غير داخلة تحت الإرادة و الجعل، لأنها اقتضاءات الأسماء الإلهية، التي هي حقائق أ ُوّل، وهذه حقائق ثوان، والممكن من حيث هو ممكن، بالنظر إلى حقيقة الإمكان، لا يقتضي شيئاً لذاته، فلابدَّ له من مرجّح، إذ وقوع أحد المتساويين بلا مرجح محال لما يلزم من التساوي، وعدم التساوي، و المرجّح لا يرجّح إلاَّ بالعلم، وإرادة المتقدمين على الترجيح. وبالنظر إلى كون علمه تعالى قديماً محيطاً، لا يقبل التغيير لاستحالته، فالممكن المعلوم حالة عدمه لا يقبل التغيير، لما يلزم من انقلاب العلم جهلاً، إذ المحال كانت معنوية أو عينية تعطى الحال بها أحكاماً ليست له، بمجرّد النظر في ذاته، فلزم من هذا: أنه تعالى ـ لا يعطي حقيقة وذاتاً من ذوات الممكنات ، حالة إيجاده، من الأحوال والصفات، إلاَّ ما علمه منه حالة عدمه لطلبه لذلك، باستعداده وطبعه، الذي هو مقتضى حقيقته. إذ انقلاب الحقائق محال. وصحّ قول حجة الإسلام الغزالي (رضي الله عنه): «ليس في الإمكان أصلاً أحسن ولا أتمّ ولا أكمل مما كان»
أي ممّا هو عليه كل ممكن في الحال، ويكون عليه في الاستقبال، من الأحوال والصفات دنيا وأخرى، يعني أنه ليس في الممكن الجائز أن يكون في حق أفراد كل حقيقة وذات نسبة إلى الوجود أعلاه وأسفله أحسن وأتم وأكمل مما كان، أي ممّ أعطيت أشخاص كل حقيقة من الأحوال والصفات والأوضاع. لأنه تعالى فعل بها وأعطاها م تطلبه باستعدادها، وتستحقه بطبعها، الذي علمه منها حالة عدمها. فكما أنه تعالى ، أخبر أنه لا يعطيها في النهاية إلاَّ وصفها بقوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ﴾[الأنعام: 6/ 139].
﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾[الكهف: 18 /49].
لأنه علمهم على تلك الصفات والأحوال في الدنيا، فكذلك في البداية، لم يعطهم من الأحوال والصفات إلاَّ ما علمهم عليه قبل وجودهم، وهي استعداداتهم. لأنه علمهم متى وجدوا يكونوا على تلك الأحوال والصفات والهيئات والأوضاع، لأنها مقتضى استعداداتهم، التي هي حقائقهم أو لوازم حقائقهم. ومن البين أن العلم ظل للمعلوم، وحكاية عنه، فهو تابع له. ولا أحسن ولا أكمل ولا أتمّ ولا أبدع ولا أحكم من إعطاء كلّ مستعدّ ماهو مستعد له. فإنه لا يطلب غيره، بل لا يقبله، فإنه لا يصلحه ولا يمشي به على حقيقته إلاَّ ذلك، ألا ترى مثلاً على استعداد الشمعة للانطفاء بالنفخ، واستعداد قبضة الحشيش اليابس للاتقاد به، ولو أراد النافخ، إذا كان غير عالم بالاستعداد، ول حكيم، فيعطي كل شيء ما يستحقه، إيقاد الشمعة بالنفخ ما قبلت ذلك، لأنه خارج عن استعدادها كما أنه إذا أراد إطفاء قبضة الحشيش بالنفخ ما قبلت ذلك كذلك، والفعل والفاعل واحد ولكن الاستعدادات مختلفة، و الطبائع متباينة، فالتجلّي الإلهي واحد.
وحقائق الممكنات تقبله بحسب استعداداتها وقوابلها. فمن الاستعدادات م يعمّ جميع أشخاص الحقيقة الواحدة، كالمتغذّي مثلاً لحقيقة الحيوان والنبات. وقد ينفرد كلّ نوع من أنواع الجنس الواحد، باستعداد وطبيعية. كاستعداد الحيوان المصوت، كل نوع إلى صوت يخالف الآخر، وما ذلك إلاَّ لاختلاف الاستعدادات. وقد لا تنحصر الاستعدادات في أشخاص النوع الواحد، ولا في أنواع الحقيقة والجنس الواحد، والحق تعالى واسع عليم بالاستعدادات على اختلافها، حكيم يضع الأشياء مواضعها التي تستحقها، جواد يعطي كلّ مستعد ما يطلبه باستعداده، وهو معنى ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أي طبيعية واستعداده ﴿ثمَّ هَدَى﴾ أي بيّن وسير وساق كل شيء بعد إيجاد، فليس له تعالى إلاَّ إعطاء الوجود للأحوال والصفات كل مستعد حسب استعداده وطلبه لذلك بلسان حاله الذي هو الاضطرار. وهو تعالى يقول:
﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾[ النمل: 27/ 62].
فكلام حجة الإسلام (رضي الله عنه) إنما هو في بيان أنه تعالى م ظلم أحداً من خلقه، ولا عدل به عمَّا علمه منه حالة عدمه، ولا نقصه خردلة ممّ طلبه باستعداده وخلقه وطبيعته، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، إن نقصاً فنقص، وإن كمالاً فكمال، وبهذا كانت له الحجة البالغة على مخلوقاته. وفي بيان أن الأحوال والصفات وا لأوضاع المجعولة التابعة للحقائق، والذوات والماهيات غير المجعولة ل يمكن أن تكون أعلا مما هي عليه ولا أ دون، لأنها مقتضى ا ستعدادات الحقائق والذوات، من غير تعرّض لشيء آخر وراء ذلك أصلاً. ولو قيل لحجة الإسلام: هل في الإمكان العقلي أن يخلق الله تعالى حقائق أحسن وأتمّ وأكمل ممّا خلق، أعني قدّر، لقال: هو م مكن ع قلاً إذا أراد، وأمَّا كشفاً فهو محال، لأن العالم مخلوق على الصورة الإلهية، وحجّة الإسلام إنما يتكلم مع الجمهور أصحاب العقول، فهو يقرّب الأمر إلى ع قولهم. ولو قيل له: وهل في الإمكان أن يعطي تلك الحقائق صفات وأحوالاً، أعلى أو أدون ممّا تقتضيه استعداداتها، التي علمها عليه قبل نسبة الوجود إليها؟ لقال: لا يمكن، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن. ووقوع خلاف العلم الإلهي مستحيل. ولو قيل له: وهل في الإمكان أن يخلق الله تعالى حقائق تقتضي باستعداداتها أحوالاً وصفات هي أحسن وألأكمل وأتم ممّا كان؟ لقال: نعم، كيف؟ وهو تعالى يقول: ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾[إبراهيم: 14/ 19].فأطلق، فجاز أن يكون أعلا. وقال: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾[الأنعام: 6/133].فأطلق كذلك.
وقال: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾[محمد: 47/ 38].فقيّد بعد المثلية.
وقال: ﴿إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾[المعارج: 70/ 40- 41].
فقيّد في هذه الآية البدل بالخيرية، يؤيد حمل كلامه (رضي الله عنه) على ما ذكرناه لا غير. قوله الذي بنى عليه هذه المقالة، عندما تكلم فيما يثمر التوكل، م نصه باختصار بعض الكلمات: «هو أن تصدّق يقيناً أن الله لو خلق الخلائق كلّهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم، وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفه؛ ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت، وأمرهم أن يدبروا الملك والملكوت، بم أعطوا من العلم و الحكمة؛ لما اقتضى تدبير جميعهم أن يزاد فيما دبّر الله به الخلق في الدنيا والآخرة جناح بعوضة، ولا أن ينقص منه جناح بعوضة ولا أن يرفع عيب أو نقص، أو مض أو ضر عمن بلي به، ولا أن يزال غنى، أو صحّة أو كمال، أو نفع عمّن أنعم عليه، بل كل ما خلق الله من السموات والأرض، وكلّ ماقسم الله بين عباده من رزق وأجل، وسرور وحزن، وعجز وقدرة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية؛ عدل لا جور فيه، وحق ل ظلم فيه، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي، وبالقدر الذي ينبغي، وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل، ولو كان، وادّخر ه مع القدرة لكان بخلاً يناقض الجود، وظلماً يناقض العدل، ولو لم يكن قادراً لكان عاجزاً. والعجز يناقض الألوهية».
يعني (رضي الله عنه) أنه تعالى أعطاهم ما أعطاهم، وكشف لهم عن علمه بالأشياء في العدم؛ فعرفوا استعداداتها وطبائعها التي تقتضيها له، وحقائق الأشياء طالبة لصفاتها وأحوالها وأوضاعها التي تعرض لها بعد الإيجاد العيني، طلباً طبيعياً لزومياً، ورأوا تلك الصفات والأحوال على اختلاف أزمنتها وأمكنتها، مترتّبة ترتيباً اقتضائياً، بحيث تكون الحالة الأولى جاذبة للتي بعدها، مستلزمة لها، كحلق السلسلة يجذب بعضها بعضاً جذباً طبيعياً، وأن الكثيف الثقيل استعداده وطلبه يقتضي أن يكون أسفل، ولا يليق به ويصلحه إلاَّ ذاك، كالأرض وما خلق منها من حيوان وإنسان، وإن اللطيف الخفيف استعداده وطبيعته يقتضي أن يكن أعلا كالسموات، وما خلق منها من ملك ونحوه. وأنَّ البارد اليابس كالأرض لا ينتظم أمره إلاَّ بمجاورة البارد الرطب كالماء، وأن اليابس الحار كالنار لا ينتظم أمره إلاَ بمجاورة الحار والرطب كالهواء، وقس على هذا، فلو عكس هؤلاء الذين أمرهم الله تعالى أن يدبّروا الخلق، بما أفاض عليهم، وأعطاهم من العلم و الحكمة خردلة ما انتظم العالم. بل لا يمكنهم زيادة خردلة ولا نقصانها، لأنه قلب للحقائق وهو محال، وتغيير لمعلوم العلم أزلاً، وهو محال أيضاً، إذ العلم لابدَّ له من معلوم. ومتى ما ظهر ظهر طبق ما تعلّق به العلم القديم، لا أزيد ولا أنقص بزمانه ومكانه، لا يتقدّم ول يتأخر، فهو تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ولا يشاء ويختار إلاَّ ما علم من كل معلوم حال عدمه، وهو ما عليه كل ممكن حالة وجوده، من جميع أحواله وصفاته التي لا نهاية لها في الدار الدائمة فلا يصح أن يقال: الحق تعالى يعجز عن شيء؛ بل هو القادر المطلق، ولكن يقال: الحق تعالى لا يفعل إلاَّ ما أراد واختار، ولا يريد ويختار إلاَّ ما علم، والمعلوم لا يتغير. فلو كان في الإمكان خلاف الواقع ، بحسب ما عليه كلُّ ممكن من الأحوال والصفات، مع طلب الممكن، أيُّ ممكن كان من الممكنات، باستعداده ولسان حاله الأحسن والأكمل بالنسبة إلى ما أعطى من الصفات والأحوال على سبيل فرض المحال، إذ لا يطلب شيء غير ما هو مستعد له البتة، لكان بخلاً يناقض الجود، وظلماً يناقض العدل، و البخل والظلم محال، فاللازم، وهو منع المستحق ماهو مستحق له، طالب له باستعداده محال. والظلم وضع الأشياء غير مواضعها، التي تستحقها باستعداداتها، والعلم والحكمة.
ولو لم يكن قادراً على ما يريد لكان عاجزاً والعجز محال.، فهو تعالى ـ عالم قادر مريد مختار. ولعلمه وإرادته واختياره لا يعطي شيئاً في الممكنات إلاَّ استعداده، لأنه مقتضى الإرادة المترتبة على العلم، المترتب على المعلوم. فتبيّن من هذا: أنه لا اعتزال ولا فلسفة، ولا جبر ولا إيجاب في قول حجة الإسلام في هذه المسألة، بل هو كلام صفوة الصفوة من أهل السنة والجماعة.
والحاصل: أن حجة الإسلام (رضي الله عنه) رمز بهذه المقالة إلى سرّ القدر، المتحكم في الخلائق، وهو الذي تنتهي إليه الأسباب والعلل، وهو لا سبب له ولا علة، فلا يقال فيه: «لم» ولا «كيف» قال (رضي الله عنه) : بعد ما قدمناه من كلامه: «وهذا الآن بحر زاخر عظيم عميق واسع الأطراف مضطرب الأمواج غرق فيه طوائف من القاصرين، ولم يعلموا أن ذلك غامض، ول يعقله إلاَّ العالمون، ووراء هذا البحر سرُّ القدر الذي تحيّر فيه الأكثرون، ومنع من إفشاء سره المكاشفون» إلى آخر المقالة. فاعتاض هذا الرمز على الإفهام، من الخاص والعام، وتباينت فيه الآراء من لدن عصر حجة الإسلام إلى هلم جرا، حيث كان هذ المركز موزعاً بين طريقة المكاشفين، وطريقة المتكلمين، فهو بين معتقد مجيب، ومنتقد غير مصيب، أما العارفون بالله فقد عرفوا صحة معناها، وأصل مبناها، غير أنه م استقام لهم تطبيق اللفظ على المعنى المراد الإستقامة الحالية، عن تكلف المسالمة من الاعتراض، وكنت أنا الحقير، أقول عند المذاكرة مع الإخوان في هذه المسألة: «المعنى صحيح واللفظ مشكل» إلى أن ورد هذا الوارد، وأمّا غير العارفين من مجيب ومعترض فهم يتخبّطون بين كلام أهل السنة و الاعتزال، والكلُّ في ناحية عن مرمى حجة الإسلام، وأكثر من بسط الكلام، في هذه المقالة، من الذين وقفنا على كلامهم الشيخ المتفّنن أحمد بن مبارك السجلماسي ثم الفاسي في كتابه «الِإبريز».
وقال: إنه فعل ذلك نصيحة للمسلمين، والله ينفعه بقصده فإنه معذور، وهو من القادحين في هذه المقالة، وممّن لم يشم رائحة للمعنى الذي ذكرناه. ولولا خشية التطويل لجلبنا أجوبة المجيبين واعتراض المعترضين، فلا تحجبنّك أيّها الواقف على ما كتبناه جلالة المتكلمين في هذه المسألة، وحقارة هذا الكاتب، عن أخذ ضالّتك عند من وجدتها، فتكون ممّن حرم الإفادة، وحجر على الله أن يتفضل على من شاء، وجرت ذيلها عليك آية: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ * أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾[الزخرف: 43/ 31- 32].
 |
 |